
المارونية السياسية ولبنان نقد ورهان
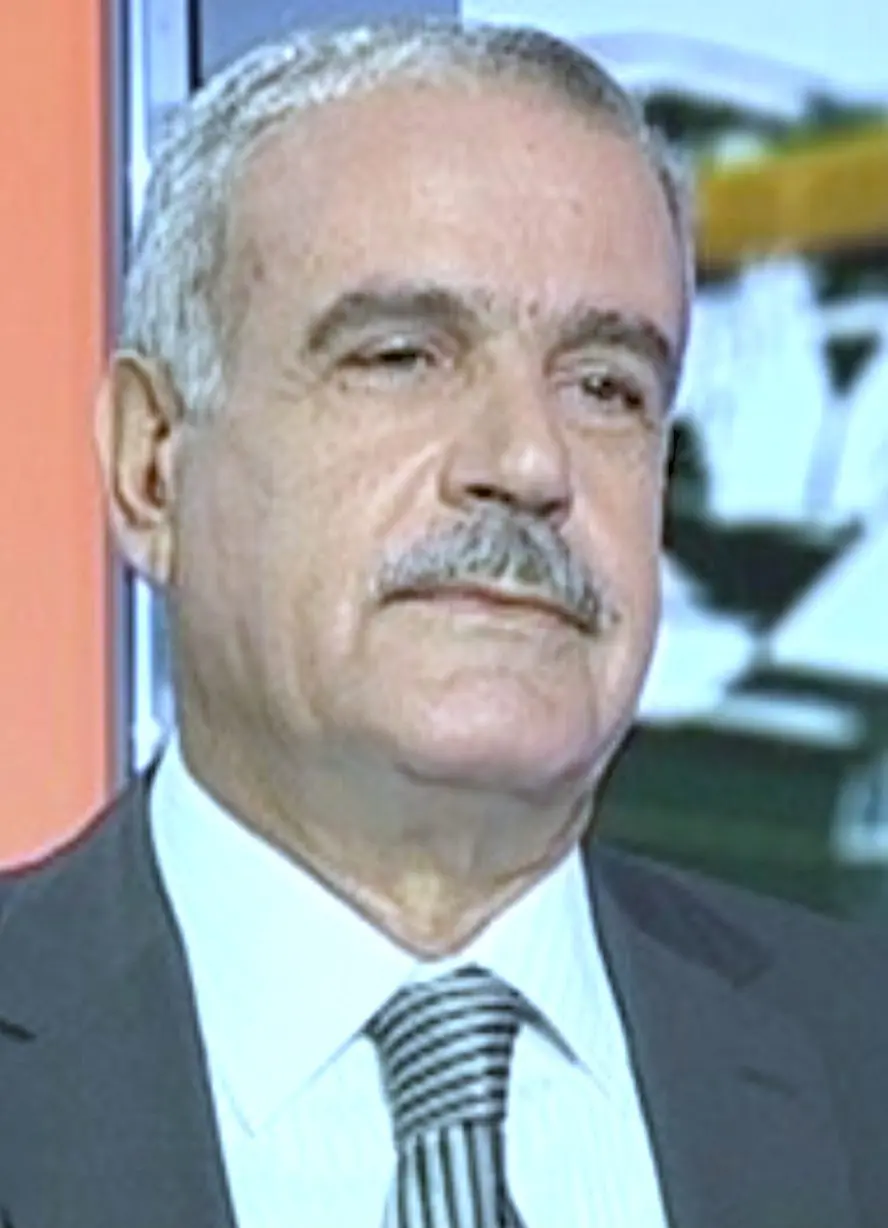
المارونية السياسية ولبنان نقد ورهان
د. ساسين عساف
ملاحظة: هذا
المقال هو من مقدّمة لكتاب معدّ للنشر بعنوان: "الموارنة والدولة اللبنانية،
إشكاليات علاقة من التأسيس إلى الحياد."
الموارنة في
لبنان، قبل أن يكونوا في أساس تكوينه
السياسي، هم فيه وجود كنسي، وجود مسيحية إنجيلية حيّة كانت منذ تأسيس مدرسة روما
(1584) ومطبعة دير مار أنطونيوس قزحيّا في وادي قاديشا (1585) وإنشاء المكتبة
المارونية في حلب (1712) على يد المطران جرمانوس فرحات (قيل فيه: أشرقت على يديه
شمس العربية في عصر الظلمات) وانعقاد مجمع
اللويزة (1736) عبوراً باحتضان الأديرة للّغة العربية في مواجهة التتريك وجمع
المحفوظات وتعليم تحت السنديانة، وانتهاء
بالدور الثقافي المكمّل الذي قام به مثقّفو عصر "النهضة العربية"
(ومعظمهم لبنانيون مسيحيون) زمن المتصرّفية.
هذا الوجود
المسيحي كان في أساس تكوين لبنان الثقافي..
وكان من الطبيعي
أن يصاحبه تأسيس للبنان السياسي، دولة لبنان الكبير في العام 1920، بإسهام مباشر
وفاعل أدّاه سياسيون موارنة من المقيمين والمنتشرين في فرنسا والأميركيتين ومصر،
توّجته جهود البطريرك الياس الحويّك.
في تلك المرحلة
كان يصعب التمييز بين العمل الثقافي والعمل السياسي لأنّ معظم العاملين في السياسة
كانوا من كبار مثقّفي الموارنة. وذلك بتأثير من حركة الإستشراق والإرساليات
الأجنبية والمدرسة السياسية الإنتدابية التي وجدت بين النخب المارونية إستعداداً
طبيعياً للإنجذاب إليها والتآلف معها.
هذه الإندفاعة
في اتجاه الغرب تقاطعت والمصالح الفرنسية في الشرق فنشأ الكيان اللبناني تاركاً
أثره في وجدان الطائفة المارونية بوصفه "كيان الطائفة." بدونها تنتفي
ضرورة وجوده!
نتيجة هذا
التقاطع حظي الفرنسيون بكيان اعتبروه معبرهم إلى المشرق العربي وحظي الموارنة
برعاية فرنسية: سياسية سلّمتهم المراكز الأساسية في الدولة الناشئة، وثقافية ضمنت
لهم عبر مؤسسات تربوية وتعليمية فرنسية تمايزاً في الهويّة الثقافية وأهليّة في
التفوّق الحضاري..
تشبّع الموارنة
من حظوتهم بهذا التمايز فكرّسوه، بضمانة فرنسية،إمتيازات في خلفيّة طموحاتهم
السياسية إزاء ما يترتّب لهم من حقوق في الدولة وإزاء ما يترتّب منها للطوائف
الأخرى فأمسى للطائفة المارونية توصيف آخر راسخ في وجدانها: "دولة
الطائفة."بدونها لا ميزة للدولة خاصّة تسوّغ قيامها بالإنفراد والاستقلال عن
سائر الدول العربية!
هذان الشعاران
تملّكا العقل السياسي الماروني، وخلال أقلّ من عقدين من السنين بدأ العمل الثقافي
يتآكل أمام شراهة العمل السياسي..
هذا التآكل أحدث
تحوّلات أساسية لا بل انحرافات جوهريّة عن خطّ التأسيس الأوّل (الثقافي) وخلّف
فجوة لا بل انقطاعاً معرفياً بين "المثقّف الماروني" وإرثه الثقافي فطغت
عليه وبترته عن أصوله وامتداداته ثقافة سياسية محلّية أشاعتها حركة أحزاب مارونية
أشهرت هويّتها الكيانية، كانت هي الحاكم في رأس النظام السياسي، (ومشاركة آخرين من
طوائف أخرى) وعرفت في سرديّات السياسة اللبنانية ب"المارونية السياسية."
هذه المارونية
الكارثيّة أضاعت على الموارنة خطوط استكمال دورهم في بيئتهم العربية وخلعت عنهم
صفة الوجود الكنسي المسيحي الإنجيلي الحيّ والنهضوي التنويري الذي لا يجد ضمانته
في حركات سياسية بل في مدى التزامه لخطّه التاريخي واستكمال إنجازه الحضاري.
باختصار هذه
المارونية الكارثيّة أطاحت بالكنيسة وفاعليّتها المشرقيّة وحضورها الإنجيلي
المميّز وتجذّرها في مشرقها العربي، وأطاحت كذلك بالإرث الماروني للنهضة العربية
المنتج ما بين أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بدعوى اختراع فكر
ماروني أسطوري مفينق (نسبة إلى فينيقيا) من جهة وبدعوى الإلتحاق الثقافي/الحضاري
بالغرب من جهة أخرى.
المعادل السلبي
للشعور بالتفوّق الثقافي (المتنكّر له) ربطاً بالإمتياز السياسي، وقوع
"المارونية السياسية" بسبب "شراهتها" للسّلطة ضحيّة
"خديعة تاريخية" قاتلة، فلا ديمومة لامتيازات تمنحها جهات خارجية لمصالح
ذاتية، ولا ديمومة لضمانات تنتهي إلى تبعية مطلقة، ولا وحدة ثابتة بين كيانين
(الماروني واللبناني) ولا تماهي ممكناً بين هويّتين (المارونية واللبنانية،
وتالياً الطائفة والدولة)
هذه
"الخديعة التاريخية" تحوّلت إلى "إثم تاريخي" مدمّر لم تبرا
منه "المارونية السياسية"بالرّغم ممّا أصابها من انتكاسات كسرت مشروعها
السياسي الذي كان عنوانه، وربّما ما زال في خيال البعض، "لبنان وطن
للموارنة" وفي هذا تراجع عن عنوان تأسيسي آخر لدى البعض (البطريرك الياس
الحويّك ليس منهم) " لبنان وطن ماروني (مارونستان) وهذا ما سعى إليه هذا
البعض بالتنسيق مع قيادات صهيونية كانت في طور سعيها إلى إقامة الكيان الصهيوني في
فلسطين.
وبعد تمكّن
"المارونية السياسية" من مفاصل الدولة أضافت إليه عنواناً آخر أشدّ
طموحاً واتّساعاً: "لبنان وطن لمسيحيي الشرق."
ثمّ توالت في
أدبيّاتها السياسية عناوين كثيرة، من أبرزها:
الموارنة علّة
وجود لبنان وضمان بقائه.
الموارنة أمّة
(هذا توصيف إرنست رينان، لازمه توصيف يواكيم مبارك أمّة فلّاحين)
الجبل الماروني
عاصم الذاتية المارونية، ومنه ما لها من خصوصيات لاهوتية وأنتروبولوجية وإتنولوجية
وسوسيولوجية وسيكولوجية وفيزيولوجية (هويّة خاصّة وفريدة!)
هذه العناوين
عملت "المارونية السياسية" على تثبيتها في الوجدان الماروني حتى حوّلتها
إلى فلسفة وجود تاريخي واستمرار، واقتربت بها من حدود الإيديولوجيا الحاكمة وفق ما
كانت تقتضيه تحدّيات المراحل وبخاصة في أثناء الحرب الأهلية حيث واجهت خصومها
آنذاك بعنوانين متلازمين: "أمن المجتمع المسيحي فوق كلّ اعتبار"
و"إذا ما خيّرنا بين الوحدة والحرّية اخترنا الحرّية.." (ما فتح مجالاً
للكلام على الفيدرالية في أدنى حدّ وعلى التقسيم في أبعد حدّ.. وما زال!)
ومن العناوين
البارزة منذ سنوات قليلة عنوانان قديمان متجدّدان مكمّلان لما سبق، يدور في شأنهما
جدال سياسي من موقعين متناقضين: موقع من يرى فيهما حلّاً تاريخياً لكلّ الأزمات
المزمنة والمستجدّة والمتراكمة، وموقع من يرى فيهما ضرباً لوحدة لبنان وإخراجه من
التزاماته العربية. هما الفيدرالية والحياد..
من تداعيات ذلك،
وفي ضوء ما آلت إليه أوضاع "المارونية السياسية" منذ إعلان دولة لبنان
الكبير إذ كانت فتيّة وتحت الوصاية
الفرنسية، حتى تاريخه نسجّل الآتي:
هويّة الموارنة
ليست إمتداداً للغرب بالتعريف الثقافي أو بالتخادم السياسي (المصلحي والحمائي) أو
بالتبعية الطوعية. وليست جسر عبور الغرب إلى الشرق كما زيّن لها وكانت هي الضحيّة
فليس ممكناً أن تكون هي الغرب في الشرق(إصطناع الهويّة)
الموارنة ليسوا
المارونية السياسية وهي ليست الموارنة. فالطائفة المارونية كيان ديني كنسي ليس
بحاجة إلى تشكّلات سياسية إختزالية. (الموارنة الأقوياء هزائم متتالية وكيانات
مأزومة)
تجربتها في
إدارة الدولة تجربة فاشلة، باستثناء تجربة الرئيس فؤاد شهاب إلى حدّ معقول بسبب
تكاثر أكلة الجبنه وراءه وعلى جانبيه. (من أخطر تداعيات هذه التجربة ليس فقط سقوط
الدولة اللبنانية وفشلها إنّما هو إخراج الموارنة من الدولة وتالياً خروجهم من
الوطن الذي أرادوه يوماً "وطنهم" أو وطناً لهم) طبعاً إنّ من شاركهم في
هذه التجربة لا تقلّ مسؤوليّته عن مسؤوليّتهم في فشلها وكذلك الطوائف التي كانت
لها تجارب خاصة بها لاحقة حمّلتها مزيداً من الفشل.
إرتباطاتها
الخارجية (المتناقضة) تبعية مطلقة جلبت للموارنة كمّاً هائلاً من المآسي، وجلبت
لها العشق من طرف واحد: إنّه الإذلال في العشق خصوصاً إذا كان العاشق من ألدّ
أعداء لبنان وله رغبة عارمة في تعدّد العاشقين)
علاقاتها
البينية علاقات حروب تدميرية إلغائيّة وتهجيرية. (الحقد هو الموّجه الأشدّ سوءاً
لهذه العلاقات وهو من أبرز عوامل سقوط "المارونية السياسية" على مذبح
"الطائف")
علاقاتها
بالطوائف المسيحية علاقات "وصاية سياسية" واستقواء وحصريّة تمثيل. (لا
أولويّات في الإنتماء الديني كما الوطني. هي قاعدة تسقطها الشراهة في العمل
السياسي)
علاقاتها مع
المسلمين تراوحت ما بين المشاركة المنقوصة في الحكم والتحالفات المصلحية
الإنتهازية (المواقع تتبدّل بتبدّل المصالح ومعها يتبدّل الخطاب السياسي ما بين
النكد والتكاذب وانعدام المعايير الأخلاقية)
هذه التداعيات
ظهّرت لدى "المارونية السياسية" ضحالة فكرية ناتجة عن اضمحلال العقل
السياسي الإبداعي المبادر والمصاب بانعزالية تكوينية هواجسيّة تستبدّ بها
سيكولوجيا الخوف الدائم من انكشاف الذات ونقدها وتصفيتها من كلّ العناوين/المشاريع
التي أعلنتها أو سعت إليها بعد التاسيس الوحدوي حتى فيدرالية التشظي والحياد
المستحيل..
لهذا يبقى
الرهان معقوداً على نخب مارونية تجتهد لصياغة مشروع سياسي إنقاذي حواري يتّسع
لتعدّديّة الرأي عناوينه مستمدّة من أعمال البطريرك الياس الحويّك، ومنها:
كلّ طائفة تدين
بدينها وإنّما نحن في الوطنية واحد (الوطنية هي الهويّة الجامعة، لا هويّات فرعية
تعلو على الهويّة اللبنانية)
إحلال الوطنية
السياسية محلّ الوطنية الدينية (الدولة الوطنية المدنية: وحدة الإنتماء للوطن
وحرية الإنتماء للدين، الوحدة في الوطن والتنوّع في الدين: مؤالفة بين الوحدة
والتنوّع)
بين الدين
والدولة ثلاث لاءات: لا قطيعة، لا تنازع، لا تماه (الدولة المدنية)
السلطان المدني
هو لجميع اللبنانيين وهو الساهر عليهم بشرائعه ومحاكمه وشرطته (الإنسان مدني بطبعه
وهو ينزع إلى السلطة المدنية، من أفكار إبن خلدون)
ليس في لبنان
طوائف بالمعنى السياسي، في لبنان طائفة سياسية واحدة يدعوها لبنانية (لا مجتمعات
سياسية طوائفية بل مجتمع سياسي واحد هو مجموع الشعب اللبناني المتعدّد في
انتماءاته السياسية)
هنا نسأل: أين كانت وأين هي "المارونية
السياسية" من هذه المبادئ التأسيسية للدولة الوطنية المدنية الوحدوية التي
أراد بناءها البطريرك الياس الحويّك، وذلك على امتداد تحكّمها بمصير الموارنة؟!

















