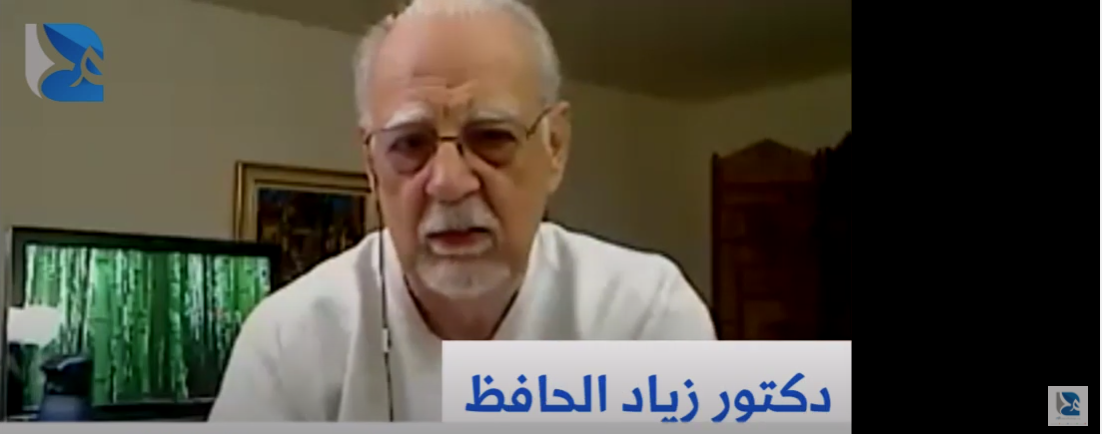قمّة البريكس: من باندونغ إلى قازان

قمّة البريكس: من باندونغ إلى قازان
د. زياد حافظ
مؤتمر قمة
مجموعة البريكس الذي عُقد في مدينة قازان الروسية على مدى ثلاثة أيام مؤتمر تاريخي
بكل معنى الكلمة. البعض اعتبره مؤتمر
باندونغ الثاني الذي كرّس آنذاك نهاية الحقبة الاستعمارية، ولكن بحضور دول عظمى
كروسيا والصين وحتى الهند بينما اقتصرت المشاركة في باندونغ على دول عالم المسمّاة
آنذاك بالثالث. فوجود هذه الدول العظمى مع
حوالي ثلاثين دولة مشاركة يعطى زخما كبيرا لمخرجات المؤتمر والتي ستكون أهم من
مخرجات باندونغ، فإنها خارطة طريق لنظام عالمي جديد. فمؤتمر قازان للبريكس يكرّس بدوره نهاية الحقبة
الاستعمار الجديد التي تلت الحقبة الاستعمارية.
آنذاك، لم تكن موازين القوّة مؤاتية لتحقيق استقلال سياسي واقتصادي لدول
الجنوب الإجمالي بينما اليوم يمكن الاعتبار أن تجمّع الدول الغربية أصبح عاجزا عن
التأثير في الشأن السياسي والعسكري وأهم من كل ذلك في الشأن الاقتصادي. فرفاهية الغرب بعد الحرب العالمية الثانية وحتى
بعد الحقبة الاستعمارية التي امتدت حتى نهاية السبعينات من القرن الماضي كانت
مبنية على السيطرة على المقدّرات الاقتصادية لدول الجنوب الإجمالي لم تعد ممكنة في
الألفية الثالثة. ويعود هذا العجز إلى
ثلاثة عوامل أساسية: العامل الأول، هو نهوض وصعود دول في آسيا وأميركا اللاتينية
التي حرصت على تمكين اقتصادها لتحصين استقلالها السياسي كالصين وروسيا خاصة بعد
خروج الاتحاد السوفيتي من المسرح الدولي. اما العامل الثاني فهو الخيارات التي
اتخذتها دول الغرب وخاصة الولايات المتحدة للخروج من الحقبة الصناعية والتحوّل إلى
الحقبة المالية الريعية. اعتقد الغرب وفي
مقدمها الولايات المتحدة أن السيطرة على شرايين المال كافية للحفاظ على الهيمنة
الاقتصادية والسياسية والسيطرة على دول العالم.
كان هذا الرهان خاطئا واليوم نشهد صعود تكتل اقتصادي وسياسي خارج الدائرة
الغربية. أما العامل الثالث في رأينا الذي
سهّل العامل الأوّل وتداعيات العامل الثاني هو وجود محور مقاوم للهيمنة الغربية
وخاصة الأميركية والذي دفع ضريبة الدم في كشف الضعف السياسي والاقتصادي وأهم من كل
ذلك الضعف العسكري للمعسكر الغربي. هذا
المحور هو محور المقاومة في غرب آسيا الذي ما زال يصنع معادلات جديدة إقليمية
ودولية تجني ثمارها في قرارات منظومة البريكس.
اختيار مدينة
قازان الروسية لعقد القمة السادسة عشر لمجموعة البريكس له دلالات سياسية وحضارية
في آن واحد. فمدينة قازان هي عاصمة
جمهورية تتارستان المسلمة وعقد المؤتمر فيها هو دلالة على نجاح التعايش بين
المسيحية الأرثودوكسية والإسلام في كنف الاتحاد الروسي ما يشكّل نقضا للسردية
الغربية التي تعتبر في هذه الآونة ان التعايش مع الإسلام الوافد إلى دول الغرب
بسبب سياسات الغرب يشكّل تهديدا لتماسك واستقرار المنظومات الاجتماعية والسياسية
في الغرب. والموقع الجغرافي لجمهورية
تتارستان له دلالات حيث يشكل التقاء البعد الاسيوي مع البعد الأوروبي لروسيا. لذلك نرى دخول دول إسلامية وزانة في مجموعة
البريكس كإندونيسيا وماليزيا والجزائر ونيجيريا وتركيا وجمهوريات آسيا
الوسطى. فالجغرافيا والحضارة متواجدتان في
قمة قازان وتنقض ادعاءات الغرب وخاصة مقولة روديارد كبلينغ أن الشرق شرق والغرب
غرب ولن يلتقيا.
أما بنية البيان
الختامي فتدلّ على اهتمامات المنظومة التي تجمّعت تحت أربعة عناوين. العنوان الأول هو "تقوية التعدّدية (multilateralism) لإقامة نظام عالمي أكثر عدالة
وديمقراطية. وعدد الفقرات تحت هذا العنوان
17 فقرة (6-23). العنوان الثاني هو تكثيف
التعاون لدعم الاستقرار والامن الإقليمي والاجمالي وكرّس له 32 بندا (24-56). العنوان الثالث هو تعزيز التعاون المالي
والاقتصادي لتحقيق تنمية عادلة وذلك في 81 فقرة (57-118). أما العنوان الرابع فهو تقوية التبادل بين
الشعوب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك في 14 فقرة (119-133). أما البند الأخير هو الإعلان ان رئاسة المنظومة
للسنة القادمة ستكون للبرازيل. وهذه
العناوين تؤكّد ان رؤية البريكس أكثر شمولية من رؤية باندونغ لأنها استفادت من
تجربة العقود السبعة الماضية وركّزت على البعد الاقتصادي والاجتماعي بما فيها من
قضايا تتعلق بالتكنولوجيا والتربية والبيئة لن نتناولها في هذه المداخلة لضيق
المساحة.
لكن ما يهمّنا
هو موقف مجموعة البريكس مما يحصل في غرب آسيا.
في الحقيقة كانت أوضاع احداث غرب آسيا موضع اهتمام خاص في المناقشات التي
حصلت بين المشاركين وتجلّى ذلك بالمساحة التي أعطيت لها في البيان الختامي. وما يلفت النظر هو غياب حتى سطر واحد عن الحرب
في أوكرانيا وتداعياتها على النظام الدولي سياسيا وأمنيا واقتصاديا. هذا لا يعنى التقليل من أهمية الاحداث في شرق
أوروبا على الصعيد السياسي لكن ما يحدث في غرب آسيا تداعياته أكثر أهمية على
الصعيد الجيوسياسي من تداعيات الصراع في أوكرانيا. فغرب آسيا هو مفتاح لآسيا بسبب الموقع الجغرافي
بين ثلاث قارات (آسيا وإفريقيا وأوروبا)، وبسبب الثروات في الطاقة، وبسبب الثقل
السكّاني، وبسبب انها مهد الحضارات التي تتمسّك بها الدول الوازنة في منظومة
البريكس، وبسبب مركزية الإسلام والعروبة في المعادلات الإقليمية والدولية.
البيان الختامي
هو بمثابة إعلان وثيقي (manifesto) امتّد في 134 بند على مدى 33 صفحة.
وأعرب في 13 بند (28-40) عن "قلقه" عمّا يحدث في غرب آسيا،
والحداد على الأرواح التي تزهق خاصة فيما يتعلّق بالقتل الجماعي من جرّاء العمليات
العسكرية للكيان الصهيوني. كما أكّد
البيان على سيادة سورية، وندّد بالعدوان الصهيوني على السفارة الإيرانية في سورية
لما يشكّل انتهاكا للسيادة السورية. كما
أكّد على ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية ودعم
عضوية فلسطين كدولة في الأمم المتحدة.
كما أعرب القرار عن قلقه البالغ لما يحدث في جنوب لبنان من قتل ودمار للبنية
التحتية والامكان المدنية الناتج عن هجوم الكيان الصهيوني. فهذه أول مرّة يتم تحديد من هو مسؤول عن ذلك
الدمار خلافا لما يصدر من بيانات من الحكومات الغربية وأيضا من الأمم
المتحدة. كما عبّر البيان عن اخذه العلم
لإجراءات الموقّتة للمحكمة الدولية استجابة لمبادرة جنوب إفريقيا فيما يتعلّق
بالإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزّة.
كما أدان البيان "الهجوم الإرهابي" على المدنيين عبر تفجير
"البيجيرات" ووسائل التواصل اللاسلكي في بيروت وفي عدد من المناطق
اللبنانية.
أكّد البيان
أيضا على سيادة سورية على كامل أرضيها وندّدت بالتواجد الخارجي غير المشروع
مستهدفا بذلك الوجود الاحتلالي غير الشرعي للولايات المتحدة وتركيا لمساحات كبيرة
من سورية. وهذا الوجود غير الشرعي سبب
مباشر لعدم الاستقرار في المنطقة. كما
أكّد البيان على التنديد لسياسة العقوبات المفروضة على سورية والتي يعتبرها غير
شرعية. وفي نفس السياق أكّد البيان على
التمسّك بالاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية في إيران الذي نقضه الرئيس
الأميركي ترامب والذي تماثل معه الاتحاد الأوروبي الذي لم يكن صادقا وجادا للعودة
إلى الاتفاق.
هذه القرارات
جيّدة وتعكس مقاربة مبنية على مبادئ وأسس قانونية. لكن في رأينا نعتبر أن المطلوب أكثر من ذلك على
صعيد الإجراءات التنفيذية. فالمجموعة التي
تحرص على التركيز على ضرورة العودة إلى القيم في العلاقات الدولية يفرض عليها أن
تأخذ موقفا بحجم الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني واللبناني.
ومجموعة البريكس تملك أوراقا ضاغطة قد تجبر الكيان على إيقاف العمل الوحشي ووقف
النار والانسحاب من غزة وفك الحصار عبر استعمال ورقة الطاقة. فالكيان يستورد ما يوازي 40 بالمائة من حاجاته
النفطية من أذربيجان عبر تركيا. فالضغط
على تركيا لإيقاف التوريد النفطي للكيان يساهم في إيقاف العدوان الصهيوني. من جهة أخرى فإن أي اعتداء على الجمهورية
الإسلامية في إيران هو اعتداء أيضا على مجموعة البريكس ما يستوجب موقفا حاسما
وقاطعا تجاه الكيان الصهيوني. في رأينا، هذا النوع من الضغط سيعطي مصداقية لطروحات
مجموعة البريكس حول تصوّرها لنظام عالمي جديد.
فإذا اقتربت من مناصرة الحق الفلسطيني وإدانة الإبادة الجماعية من قبل
الكيان فعندئذ تتعزًز مصداقية البريكس.
وإذا ما ابتعدت عن ذلك فستتناثر مصداقيتها.
لكن بغض النظر
عن الاعتبارات التي ذكرناها في مقاربة الإبادة في فلسطين ولبنان ورأينا حول
مصداقية المجموعة فإن عالم الجنوب الإجمالي يريد الالتحاق بهذه المنظومة حيث عدد
طلبات الشراكة فيها يفوق الأربعين. وقد
تمّ توجيه الدعوة للانتساب إلى 13 دولة إضافية للمجموعة الحالية التي تضم كل من
روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، ومصر، ودولة الامارات، واثيوبيا،
والجمهورية الإسلامية في إيران. الارجنتين
انسحبت من المنظومة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أوصلت إلى الرئاسة خافيي
ميلاي فرفض الانتماء إلى تلك المجموعة ليؤكّد اصطفافه إلى جانب الولايات المتحدة.
اما بلاد الحرمين فلم تقبل رسميا الانضمام كما لم ترفضها (رغم اعلان وكالة رويتر
عن رفض رسمي لم نجد تأكيدا له من السلطات في بلاد الحرمين) وإن شاركت في القمة
ومثّلها وزير خارجيتها. فبلاد الحرمين لا
تريد الاختيار بين معسكرين متنافسين وتحتفظ لنفسها دورا مستقلاّ كما تريد مراعاة
مصالحها مع الدول الغربية وذلك إلى أن تنجلي الأمور على الصعيد الدولي. وتعويضا عن الالتباس بموقف بلاد الحرمين وما
يمكن أن يؤثّر على دور المجموعة في سياسة الطاقة فإن انضمام الجزائر ونيجيريا يعوض
نسبيا "الفراغ" الذي قد يكون موقتا على صعيد الوزن الطاقوي للمجموعة ل
"عزوف" بلاد الحرمين عن قبول الانضمام رسميا. لكن بلاد الحرمين ما زالت ملتزمة بقرار تسعير
برميل النفط بعملات غير الدولار إذا ما اقتضت مصلحتها ذلك. كما أنها استجابت لدعوة التقارب مع الجمهورية
الإسلامية في إيران وأعلنت مؤخّرا عن إجراء مناورات بحرية مشتركة معها. وهناك سلسلة من القرارات التي اتخذتها بلاد الحرمين
تنسجم مع توجّهات البريكس منها توثيق العلاقات الصناعية مع عدد من الدول المنخرطة
فيها. أما الدول الثلاثة عشر الجديدة التي
دُعيت للشراكة في المنظومة فهي الجزائر، وبلاروسيا، وبوليفيا، وكوبا، واندونيسيا،
وماليزيا، وكازخستان، ونيجيريا وتايلاند، وتركيا، واوغندا، واوزبكستان،
وفيتنام. والانضمام إلى المجموعة دول من
إفريقيا وآسيا يعيد إحياء وتعزيز إحدى إفرازات باندونغ وتجمع دول عدم الانحياز وهو
التجمّع الافروآسيوي الذي تأسس سنة 1957 أي بعد سنتين من انعقاد مؤتمر باندونغ.
ومفهوم
"الشراكة" يتجنب السلبيات التي يمكن أن تنجم عن تداعيات العضوية الكاملة
في المنظومة وتسمح لمرونة أكبر للدول التي تريد الاستفادة من الفرص التي تخلقها
منظومة البريكس. ومن يتابع المحادثات التي
جرت قبل انعقاد القمة حول توسّع المنظومة يجد أن الدول المؤسسة تعي أبعاد
التحدّيات السياسية والاقتصادية التي ستواجه الدول التي ستنضم. كما تعتبر الدول المؤسسة أن فترة
"الشراكة" تعطي الفرصة للتأقلم مع معطيات التحوّلات التي ستحصل من جرّاء
إطلاق المبادرات والإجراءات التنفيذية لاستكمال البنية المؤسسية للمنظومة. كما ان عامل الزمني سيساهم في تنقيح التباينات
ويزيد من التجانس في البنى والسياسات الاقتصادية والخيارات السياسية لمجمل
الدول. فالدول المؤسسة لا تريد الاستعجال
في التوسّع دون مقاربة تلك التباينات من جهة ودون الانتظار لتوسيع عدد
المنتسبين. فهذه هي فلسفة ابتكار مفهوم
"الشراكة". وهنا لا بد من
الإشارة أنه جرى على هامش المؤتمر الإعلان عن الوصول إلى تفاهم بين الصين والهند
حول النزاع المزمن حول الحدود المشتركة والذي كان سببا للتوترات الخطيرة بين
الدولتين. وهذا التفاهم قد يقضي على
مراهنة الولايات المتحدة للاستفادة من تصدّع في العلاقات بين الدول المؤسسة. فقرار الهند بالوصول إلى تفاهم مع الصين يمكن
اعتباره قرارا تاريخيا يعزّز فرص نجاح مسير منظومة البريكس. وهذا التطوّر يثبّت بروز رباعية ركنية للمجموعة
قوامها روسيا والصين والهند والجمهورية الإسلامية في إيران.
ودول البريكس
التسع تشكّل أكثر من 40 بالمائة من عدد سكّان العالم وأكثر من 30 بالمائة من
الناتج الداخلي بينما دول المجموعة السبع تشكّل أقلّ من 28 بالمائة من الناتج
الداخلي. فانضمام 13 دولة الى المنظومة
يزيد من قوّة الكتلة الاقتصادية والسياسية التي تشكّلها بينما الغرب في حالة تراجع
سياسي واقتصادي مستمرّ إن لم يكن مستداما!
لكن المهم هو
مخرجات المؤتمر التي تؤكّد على بعده التاريخي العالمي. فالبيان الختامي هو بمثابة اعلان يُظهّر قراءة
جديدة للعلاقات الدولية ولتوجّهاتها المرتقبة في مقاربة التحدّيات التي تواجه
العالم. فتناول البيان تطلّعات الدول
وقاعدة العلاقات الدولية مؤكّدا القرارات التي اتخذت في الدورات السابقة. فإعادة التأكيد على ضرورة إقامة نظام دولي
متعدّد الأقطاب و"أكثر إنصافا وديمقراطية وتوازنا" يحدّد المرتكزات، أي
قطبية متعددّة، وانصاف، وديمقراطية، وتوازن في العلاقات. العبرة ستكون في الممارسة والدول المؤسّسة
تشدّد على الندّية في العلاقات وعلى احترام الآخر. سلوك الصين وروسيا والهند في علاقتهم المتبادلة
نموذج لما يدعون إليه. فاحترام الخصوصية
يتلازم مع التركيز على المصالح المشتركة وليس على نقاط الخلاف التي قد تُحل عبر
الثقة المتزايدة. والدليل على ذلك الإعلان
عن التوقيع على تفاهم بين الصين والهند الذي ينهى خلافا مزمنا. هذه المبادئ تتناقض
مع المفهوم الفضفاض ل "نظام الاحكام" (rules based order) الذي تروّج له الدول الغربية وخاصة
الولايات المتحدة والذي لا يستند إلى أي قاعدة قانونية غير إملاءات تلك الدول على
سائر دول العالم. بالمقابل، تشدّد منظومة
البريكس على مركزية الأمم المتحدة التي يجب أن تخضع لمراجعات في بنيتها وآليات
عملها وخاصة فيما يتعلّق بمجلس الامن.
فمنظومة البريكس لا تعتبر نفسها بديلا عن الأمم المتحدة، بل مساعدة
لتطويرها وتفعيلها وفقا لمفاهيم التعدّدية، والانصاف، والديمقراطية، والتوازن. كما تشدّد على ضرورة إجراء إصلاحات في سائر
المنظمات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي على قاعدة الاعتراف بالدور المتنامي
للدول النامية ولمساهمات مجموعة البريكس في إصلاح وتحديث نظام المدفوعات الدولية.
الإصلاح المطلوب
في المؤسسات الدولية وخاصة لتلك المنظومة التي نشأت في بريتون وودز بعد الحرب
العالمية الثانية هو إيجاد نظام مدفوعات بعيد عن مركزية الدولار. هذه الدعوة الصريحة للخروج عن سيطرة وهيمنة
الدولار وما تتضمنه من هيمنة وسيطرة سياسية واقتصادية ومالية للولايات المتحدة هو
جوهر التحوّل الاقتصادي والمالي الذي تسعى منظومة البريكس لتحقيقه. والتغيير في منظومة المدفوعات ستساهم في تحرير
اقتصادات دول الجنوب الإجمالي من تداعيات هيمنة الدولار في نظام المدفوعات الدولية
وستعزّز استعادة السيادة الاقتصادية والسياسية على مقدرات تلك الدول. ومن الواضح أن الولايات المتحدة لن تقبل
بالتخلّي عن هيمنة ومركزية الدولار فلذلك لا بد من نظام مدفوعات بديل يرتكز على
التبادل في العملات الوطنية، وهذا ما بدأ يحصل، إلى أن يتم الاتفاق والتفاهم بين
دول منظومة البريكس على وحدة نقدية رقمية للتبادل التجاري. ولسنا في إطار التوسّع في البحث حول المعضلات
التي ترافق موضوع الوحدة النقدية الرقمية المطلوبة إلا أننا نشهد أن الدول المؤسسة
للمنظومة تأخذ بعين الاعتبار تجربة اليورو وما رافقها من سلبيات لا تستطيع
المنظومة الأوروبية تجاوزها بسبب التباين في البنى الاقتصادية والسياسات المالية
والنقدية للدول الأعضاء. فهناك نضج في
التفكير الجماعي لقيادات دول البريكس التي لا تريد أن تطلق مبادرة استراتيجية
كالوحدة النقدية الرقمية دون معالجة المعضلات التي سترافق إطلاق تلك العملة. هذا لا يعني بالمطلق أن هناك استعصاء على إيجاد
البديل للدولار، ولكن إدراكا عميقا بأن تداعيات إطلاق عملة جديدة للتبادل التجاري
والمدفوعات الدولية على البنى الاقتصادية للدول المعنية يجب معالجتها مسبقا أو
التحضير لمواجهتها عند اقتضاء الامر. لذلك
تجنّبت القمة عن إطلاق تلك المبادرة لكنها ركّزت على بناء المؤسسات التعاونية وفي
طليعتها "البنك الإنمائي الجديد" الذي مركزه مدينة شانغهاي. كما شدّدت
القمة على توثيق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية
والتكنولوجية والتربوية لما في ذلك من منفعة مشتركة ولتمهيد الأرضية لتكامل
اقتصادية ونقدي.
لكن لا بد من
الإشارة إلى بعض الإنجازات التي حققتها المنظومة وتتعلّق بالإصلاح في الشرايين
المالية. لقد توافقت دول البريكس على
إطلاق مؤسسة للمقاصة في المدفوعات. كما
توافقت على استعمال منصات وسائل التواصل الاكتروني في المعلومات في القضايا
المالية. فهناك المنصة الروسية والمنصة
الصينية والمنصة الهندية والمنصة الإيرانية التي أصبحت معتمدة بين هذه الدول والتي
ستتحوّل إلى منصّة واحدة بديلة عن منصة السويفت.
كما توافق المجتمعون على إطلاق مؤسسة إعادة التأمين التي ستحرّر دول
البريكس من هيمنة المؤسسات الغربية كمؤسسة لويدز البريطانية.
قمة البريكس
وضعت خارطة الطريق لإيجاد عالم جديد لا يخضع لهيمنة أي طرف، بل مبني على احترام
الاخر والتعامل بالندّية. كان ذلك واضحا
في طريقة التعامل بين الدول الكبيرة كروسيا والصين والهند مع الدول الأصغر حجما
جغرافيا أو اقتصاديا أو سكّانيا. فالجميع
كانوا على طاولة واحدة ويستمعون لبعضهم.
المحادثات الجانبية لم تكن أقّل أهمية عن الاجتماع العلني ما ساهم في تعزير
رغبة الدول الصغرى في التمسّك بالمنظومة الجديدة وخاصة بين الدول الإفريقية
الحاضرة. والأمر أكثر من ذلك، فالرئيس
الروسي فلاديمير بوتين صرّح أن المحرّك الأساسي للنمو العالمي سيكون في القارة
الإفريقية وأميركا اللاتينية ورغم انسحاب الارجنتين والدور الملتبس للبرازيل بسبب
اعتراضه على دخول فنزويلا في المجموعة.
فعلى ما يبدو فإن التشكيلة الحكومية في البرازيل تصطف مع مجموعة العشرين
أكثر من مجموعة البريكس علما أن مجموعة الدول السبع الغربية واليابان اختطفت
مجموعة العشرين. على كل حال يمكن مقاربة
بشكل منفصل دور البرازيل التي ستترأس مجموعة البريكس ابتداء من أول كانون
الثاني/يناير 2025.
الرئيس الروسي
يعي كل ذلك وفي تصريح له في المناقشات التي حصلت قال إن التحوّل إلى عالم متعدّد
الأقطاب لا يجري بطريقة سلسلة لأن عددا من الدول التي تريد ذلك ما زالت تفكّر
بذهنية الدول المهيمنة. بمعنى آخر لم
يتحرّر العقل الجماعي لهذه الدول من سيطرة العقل الغربي بشكل عام والأميركي بشكل
خاص. هذا الاعتراف الجريء والواقعي يدلّ
على مدى نضج وواقعية التفكير في دول البريكس.
فهناك من سيتعبر أن الخطوات الحذرة تعكس ضعفا في المواقف وتصدّعا بين
القيادات بينما في رأينا تعكس وعيا كاملا للتحدّيات والحرص على النجاح وعدم الوقوع
بالمطبّات.
على كل حال الزمن هو الفيصل وهو من سيطلق الاحكام النهائية.
* باحث وكاتب اقتصادي سياسي
******************